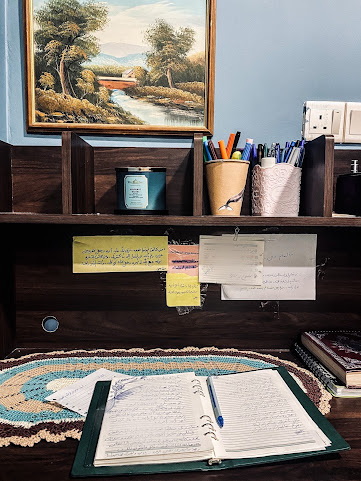الأرض المجهولة

في صبيحة إحدى الأيام، خرجنا أنا وأخي لنتسكّع حول البساتين، تلامس الرمال الناعمة أقدامنا، وتداعب أشعة الشمس الدافئة أجفاننا، نتأمل البساتين الأخاذة كثيفة الشجر والثمر، نأنس بمنظرها، ونطرب لشدوها.. نقضي جلّ الصباح في زيارة البساتين، نسلم على أصحابها، نأخذ أخبارهم، لا يفوتنا في القرية أيّ شيء قديم أو مستحدث.. نعرف القرية كمّا نعرف أنفسنا، لكنّ يفوتنا معرفة بعض أراضيها المجهولة، وكانت إحداها محط نظر وجذب، بمجرد المرور عليها تحفنا المهابة، نتجمد، كأن رؤوسنا الطير ممّا نشهد. أقول لأخي -بعد تكرر المشهد- : ألاّ نكسر حاجز الخوف ونلج؟ : لكننا لا نعلم لمن هي؟ أجيب: هذا أجمل ما في الأمر، ندخل ونخرج بهدوء. برحابة عالية يوافق، لا يطيل النقاش، لا يفكر في الأسباب، لا يفسر أسباب انصياعه السريع، لم يفسر أحدنا للأخر سر رغبته، نجاري رغباتنا بالمسير نحو الوجهة، نمشي في وتيرة واحدة نحو البستان، القابع في أخر الطريق، طريق غير معبد كحال أغلب الطرق في القرية.. في أثناء مسيرنا، أمعن النظر في تفاصيل البساتين الممتدة عن يميني وشمالي، صغيرة كانت أم كبيرة، قليلة الشجر أم كثيفة.. هذه الجنّان التي أبدعها الخالق، وم